الله والشر والمصير (2) كوستي بندلي
الدينونة والمصير – الجزء الثاني
ثانياً: هل أن هذه الحالة نهائية؟
الجواب بحسب التقليد فى الأرثوذكسية:
1 – تعلّم الكنيسة الأرثوذكسية أن المرء لا يسعه أن يبلغ حالة نهائية من حيث مصيره، قبل قيامة الأجساد، أى قبل ترميم كيانه الذاتى بجملته يفعل هذه القيامة، وقبل اكتمال كيانه الجماعى بفعل تجمّع البشرية كلّها بعد نجاز تاريخها:
أ – فلا بدّ من ترميم الكيان الذاتى بأكمله:
إذ الروح إنما هى إلا لبّ هذا الكيان وخلاصته كما قلنا، لكنها ليست الكيان كلّه.
الروح كالعين (راجع المثل السائر “العيون مرآة الروح“، ولاحظ فى اللغة العربية الترادف بين “النفس“ و “العين“ و “الشخص“ كما عندما نقول: “هذا هو الشخص نفسه“ و “هذا هو الشخص عينه”): إنها تختزل الشخص البشرى ولكنها لا تغنى عن سواها من عناصره.
والروح، بتشبيه آخر، إنما هى بمثابة الطفل المولد حديثاً.
هكذا تُرسم فى الأيقونات الأرثوذكسية، حيث نرى مثلاً فى أيقونة رقاد العذراء صورة السيّد واقفاً أمام جسد أمه المسجى، حاملاً فى يديه طفلاً مقمطاً بالبياض يرمز إلى الروح الطاهرة التى تقبّلها.
إنما يبقى على الطفل المولود أن يمتد ويكتمل ليبلغ ملء قامته الإنسانية على كل الأصعدة.
ب – ولا بدّ، من جهة أخرى، من اكتمال الكيان الجماعى للإنسان باجتماع البشرية كلها فى نهاية التاريخ.
فالمسيحية، بمقدار ما تؤكّد على أهمية الفرادة الشخصية، تؤكّد أيضاً على أهمّية ارتباط الفرد بالجماعة البشرية، هذا الارتباط الذى لا يمكنه بدونه أن يحقق ملء أبعاد كيانه.
والمسيح، فى إيماننا، إنما قد وحد الطبيعة البشرية بحيث أن هذه الطبيعة تتواجد فى كل شخص متخذة لديه وجهاً فريداً.
من هنا إننا بحاجة إلى تواجدنا معاً لكى يكتمل مصير كل واحد فينا. أن ننتظر بعضنا بعضا.
لقد قالت الرسالة إلى العبرانيين عن أبرار العهد القديم:
(فَهَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ، مَشْهُوداً لَهُمْ بِالإِيمَانِ، لَمْ يَنَالُوا اَلْمَوْعِدَ، إِذْ سَبَقَ اللهُ فَنَظَرَ لَنَا شَيْئاً أَفْضَلَ، لِكَيْ لاَ يُكْمَلُوا بِدُونِنَا) (عبرانيين 11: 39، 40).
فقد كان على أجداد العهد القديم أن ينتظروا أحفادهم ليروا وإياهم الخلاص الذى أتى به الرب يسوع المسيح فى مجيئه الأول.
كذلك فإن الأجيال التى عاشت وتعيش قبل هذا المجئ وبعده ستنتظر بعضها بعضاً لتحظى معاً باكتمال الخلاص عند المجئ الثانى المجيد.
 2 – فإذا كان مصير كل إمرئ بعد انتقاله الشخصى مصيراً غير نهائى، وإذا كان على الجميع أن ينتظروا يوم القيامة لاكتمال هذا المصير، إلا أن انتظاراً يختلف عن انتطار باختلاف الموقف من الله الذى بلغه كل انسان فى لحظة انتقاله:
2 – فإذا كان مصير كل إمرئ بعد انتقاله الشخصى مصيراً غير نهائى، وإذا كان على الجميع أن ينتظروا يوم القيامة لاكتمال هذا المصير، إلا أن انتظاراً يختلف عن انتطار باختلاف الموقف من الله الذى بلغه كل انسان فى لحظة انتقاله:
أ – فبالنسبة للذين أسلموا أنفسهم كلّيا لله، يكون هذا الانتظار استباقاً للفرح ومستنيراً به منذ الآن.
إنه، بمعنى، كانتظار الصديق والحبيب الآتى لا محالة، وهو تمتع مسبق بحضوره.
مع هذا الفارق أن الصتديق والحبيب المنتظر حاضر فى الفكر والشعور وحسب، فى حين أن الله الحاضتر فى الإنسان إنما هو أقرب إليه من ذاته، ويتخذ هذا الحضور فى الآخرة شكل معيّة حقيقية.
فقد رأينا الرسول بولس يقول: “لِيَ اِشْتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ اَلْمَسِيحِ. ذَاكَ أَفْضَلُ جِدّاً “ وإن كانت مدعوّة إلى مزيد من الاكتمال على قدر اكتمال كيان الذى يحياها.
من هنا أن اللوعة التى تمتزج بالفرح عند انتظار الصديق والحبيب إذا ما تباطأ هذا فى قدومه، ليس لها من مجال هن، بلّ الفرح صافٍ لا تشوبه شائبة.
تلك الحالة البهجة يصوّرها سفر الحكمة:
(نِفُوس الصِدِّقِيين فِى يدِ الله، وَلا يَمِسَّها عَذَابٌ. لِقدّ بدَا خُرُوجِهِم مِنْ اَلْعَالَمِ مُصِيبَة وذِهَابِهِم عَنَّا فّنَاء، وَلَكنهم فِى سَلامٍ) (حكمة 3: 1- 3).
علما بأن “السلام“ فى لغة الكتاب، يشير إلى التمتع بكلّ الخيرات فى ظلّ معاشرة الله.
تلك هى حالة الشهداء كما وصفها سفر الرؤيا:
(بَعْدَ هَذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعٌ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَعُدَّهُ، مِنْ كُلِّ الأُمَمِ وَاَلْقَبَائِلِ وَاَلشُّعُوبِ وَاَلأَلْسِنَةِ، وَاقِفُونَ أَمَامَ اَلْعَرْشِ وَأَمَامَ اَلْحَمَلِ، مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ اَلنَّخْلِ.
وَهُمْ يَصْرُخُونَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ: { الْخَلاَصُ لإِلَهِنَا اَلْجَالِسِ عَلَى اَلْعَرْشِ وَلِلْحَمَلِ }.
وَجَمِيعُ اَلْمَلاَئِكَةِ كَانُوا وَاقِفِينَ حَوْلَ اَلْعَرْشِ وَاَلشُّيُوخِ وَاَلْحَيَوَانَاتِ الأَرْبَعَةِ، وَخَرُّوا أَمَامَ اَلْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسَجَدُوا لِلَّهِ
قَائِلِينَ: {آمِينَ! اَلْبَرَكَةُ وَاَلْمَجْدُ وَاَلْحِكْمَةُ وَاَلشُّكْرُ وَاَلْكَرَامَةُ وَاَلْقُدْرَةُ وَاَلْقُوَّةُ لإِلَهِنَا إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ}
وَسَأَلَنِي وَاحِدٌ مِنَ اَلشُّيُوخِ: {هَؤُلاَءِ اَلْمُتَسَرْبِلُونَ بِالثِّيَابِ اَلْبِيضِ، مَنْ هُمْ وَمِنْ أَيْنَ أَتُوا؟}
فَقُلْتُ لَهُ: { يَا سَيِّدُ أَنْتَ تَعْلَمُ }. فَقَالَ لِي: { هَؤُلاَءِ هُمُ اَلَّذِينَ أَتُوا مِنَ اَلضِّيقَةِ اَلْعَظِيمَةِ، وَقَدْ غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيَّضُوهَا فِي دَمِ اَلْحَمَلِ.
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هُمْ أَمَامَ عَرْشِ اَللهِ وَيَخْدِمُونَهُ نَهَاراً وَلَيْلاً فِي هَيْكَلِهِ، وَاَلْجَالِسُ عَلَى اَلْعَرْشِ يَحِلُّ فَوْقَهُمْ.
لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ وَلَنْ يَعْطَشُوا بَعْدُ وَلاَ تَقَعُ عَلَيْهِمِ اَلشَّمْسُ وَلاَ شَيْءٌ مِنَ اَلْحَرِّ،
لأَنَّ اَلْحَمَلَ اَلّذِي فِي وَسَطِ اَلْعَرْشِ يَرْعَاهُمْ، وَيَقْتَادُهُمْ إِلَى يَنَابِيعِ مَاءٍ حَيَّةٍ، وَيَمْسَحُ اَللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ }) (رؤيا 7: 9-17).
هؤلاء الصدّيقون الذين:
(دَخَلُوا إِلَى فَرَح رَبّهِم) (متى 25: 21).
قد أصبحوا، لكونهم صاروا أكثر قربا من الله، أدنى إلينا نحن أيضاً به ومن خلاله.
لذا فهم يتحسّسون لحاجتنا ويشفعون بنا.
علما أن شفاعتهم هذه لا تضاف إلى شفاعة المسيح كما قد يُظنّ.
ولكنهم، وهم أعضاء فى جسد المسيح، إذ قد أصبحوا أكثر اقترابا من الرأس الذى هو المسيح، صاروا بالتالى مساهمين بنحو أخص فى شفاعته.
ب – أما الذين تركوا الحياة وهم فى حالة رفض عميق ونهائى، فهؤلاء قد حدّدوا بذلك مصيرهم إلى الأبد.
عليهم ينطبق ما قاله السيد المسيح عن الذين يجدّفون على الروح القدس، أى الذين يرون النور الإلهى ويرفضون الانصياع له، متشبثين بظلمتهم عن إصرار وتصميم:
[وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى اَلرُّوحِ اَلْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ لاَ فِي هَذَا اَلْعَالَمِ وَلاَ فِي اَلآتِي) (متى 21: 32).
هؤلاء يجعلون أنفسهم فى عذاب هو انتظار العذاب النهائى واستباق له، ذلك العذاب الذى سيبلغ كماله فيهم عند القيامة التى بها يكتمل كيانهم من جهة (ولكنه يكتمل منحرف، مشوّه، فارغ، ليشتد عذاب الفراغ على قدر امتداده فى كيان متكامل)، وتكتمل من جهة أخرى الوليمة البشرية التى أ قصوا أنفسهم عنها (فيتلوّعون على قدر اكتمال ما حرموا ذواتهم منه).
بؤس هؤلاء ناتج عن انهماكهم بذواتهم، وهو انهماك لا يبعدهم عن لقاء الله وحسب بلّ عن لقاء الناس أيضا.
هذا ما عبّر عنه أحد رهبان صحراء مصر“الأنبا مكاريوس“، عندما وصف الجحيم بقوله:
“هناك لا يسع المرء أن يرى أحدًا وجها لوجه“
أى أن المواجهة، التى هى تعبير عن اللقاء، تكون مستحيلة بالنسبة للذين غرقوا فى جحيم عزلتهم.
وما الجحيم، فى آخر المطاف، إلا جحيم العزلة التى يرتضى المرء أن يغلق على ذاته ضمن جدرانها فى حين أنه مدعوّ فى الصميم إلى فرح المشاركة.
وقد كتب اللاهوتى الأرثوذكسى “بتول أفدوكيموف“ بهذا الصدد:
“يمكن تصوّر جهنّم على شاكلة قفص مصنوع من مرايا. بحيث لا يمكن للمرء فيها أن يرى سوى وجهه الذاتى. مرَجّعا ومتواجدًا إلى ما لا نهاية دون أن تلتقيه أية نظرة أخرى. وإذا ما لم يرَ المرء سوى ذاته، فإنه يشبع منها حتى الغثيان“.
ج – أما الذين تركوا الحياة وهم تائبون إلى الله، أى عائدون إليه، ولكنهم لم يتمكّنوا من ترسيخ هذه العودة، لم يستطيعوا تجسيدها بما فيه الكفاية بمواقف وأعمل، وفقا لوصية الإنجيل:
(فَاصْنَعُوا أَثْمَاراً تَلِيقُ بِالتَّوْبَةِ) (لوقا 3: 8).
أى الذين اتجهوا فى قرارة نفوسهم إلى الله واعتبروه قطب حياتهم، ولكن اتجاههم هذا بقى غير مستقر بما فيه الكفاية ومعرضاً للتذبذب والاضطراب.
هؤلاء هم أساساً فى معية الله، ولكن هذه المعية تكتنفها عوائق تحول بينهم وبين التناغم الكلّى مع الله وبلوغ الألفة التامة معه.
حالتهم تشبه إلى حدّ، ما يحدث فى علاقات المحبّة البشرية (من صداقة وحب مثلاً) إذا لم تكتمل بعد بلّ لا زالت تعكّرها الانطواءات والتشنجات، بحيث تعاش المحبة على خلفية مأساوية.
من هنا إن الفرح والعذاب يتنازعان هؤلاء، ففرح اللقاء يتواجد عندهم مع عذاب البعاد.
هؤلاء يمكن للصلوات التى نرفعها من أجلهم أن تساعدهم على تجاوز العوائق وبلوغ حالة أكثر صفاء فى علاقتهم بالله، والتمتع بالتالى بانتقاص الألم وازدياد الفرح، كما أن صلواتنا بعضنا من أجل بعض فى هذه الحياة تدعّم وتساند مسيرة كل منا إلى الله.
الرجاء الذى يتجاوز كل تحديد:
1 – هذه التحديدات العقائدية، على أهميته، يتجاوزها الرجاء، وهو من صلب تراث الكنيسة الأرثوذكسيةالشرقية، بأن تتم، فى آخر المطاف، المصالحة الشاملة ويقبل الجميع، دون استثناء، إلى نور الله.
هذا الرجاء قد عبّر عنه عدّة آباء عظام، منهم غريغوريوس النيصصى الذى كان يرجو حتى خلاص الشيطان نفسه، ومنهم غريغوريوس النزينزى ومكسيموس المعترف.
وقد كان لأعظم القديسين (ومنهم اسحق السريانى) جرأة الصلاة حتى من أجل الشياطين.
والرجاء نفسه مسجّل فى طقوس الكنيسة: فهى فى أفاشين خدمة “السجدة“ (وهى خدمة غروب اثنين العنصرة) تصلى من أجل المضبوطين فى الجحيم)، كما أنه، فى الإفشين الثالث للقديس باسيليوس الذى يُتلى فى هذه الخدمة، تصلّى من أجل كل الراقدين منذ بداية الخليقة.
فى قانون (أكاثسطون) من أجل الأموات وضعه أسقف روسى تألم من أجل الإيمان، وقد التقط هذا القانون، بين الحربين العالميتين، فى دير أيوب الصديق فى بوتشايف، نجد هذه العبارات المذهلة:
– امنح الصفح للذين ماتوا دون توبة.
-إن ظلمات النفس البعيدة عن الله لرهيبة، يرتعد المرء عند مجرّد التفكير بها. أيها الهالكون، ألا فلينزل عليكم كالندى نشيد هللويا!!!.
 2 – إنما رفضت الكنيسة الأرثوذكسية أن تجعل من موضوع هذا الرجاء عقيدة.
2 – إنما رفضت الكنيسة الأرثوذكسية أن تجعل من موضوع هذا الرجاء عقيدة.
لذا أدانت رأى أورجانوس الذى كان يؤكد أن الجحيم ليس أبدياً.
هذه الإدانة ينبغى فهمها على محملها الصحيح.
فلا يجوز، بحال من الأحوال، تأويلها على أنهأ تأكيد لأبدية الجحيم.
إنما الغاية منها التشديد على أمور هى فى غاية الأهمية:
أ – التأكيد على احترام الله الفائق لحرية الإنسان:
وهو مقياس حقيقة حبّه لنا, لأن المحبّة الحقيقية إنما تحترم إلى أبعد حد حرية المحبوب وتتحاشى إلغاء كيانه المتميّز وإحتواءه فى كيان المحبّ.
فالله يذهب فى احترامه لحرية الإنسان إلى حد أنه يرتضى بان يقول له الإنسان “لا” حتى النهاية، مما يعنى أنه يتقبل أن يلحق به الإنسان خيبة نهائية وأن يحمل هو نهائياً الجرح الذى يصيبه من جرّاء عذاب اختاره الإنسان لنفسه.
فقد قالت إحدى القديسات: “أن الجحيم إنما هو عذاب الله أولاً”.
هذا ما يناقض تصوّر سارتر لإله ساحق يحطم مقاومة الإنسان ليخلّصه رغم أنفه (فى مسرحية الشيطان والله).
ب – التأكيد على خطورة الخيار فى الحياة الحاضرة:
فهى المجال الأكيد الوحيد المعطى لنا لتقبل خلاص الله. ندخل عالم المجهول، المكتنف بالغموض.
صحيح أننا متيقنون من أن رحمة الله قائمة فى هذه الحياة وبعده، ومن أن الله يبقى أمينا لنفسه، أميناً لعهد الحب الذى قطعه لنا.
ولكن لا شئ يؤكد لنا أننا سوف نستطيع الانتفاع مع هذه الرحمة والتجاوب معها إذا ما تركنا الحياة ونحن متحجرون فى موقف رافض.
هذه الخطورة تدعونا إلى اليقظة الدائمة، وهى موقف محورى فى الإنجيل.
3 – من هنا أننا نجد فى التراث الأرثوذكسى تأكيدًا مزدوجا تعبر عنه قصة أنطونيوس الكبير وسكّاف الإسكندرية.
فقد كُشف لأنطونيوس أن سكّافا ما فى مدينة الإسكندرية بلغ مرتبة من القداسة تفةق مرتبته.
فأراد أن يكتشف سر قداسته. فقصده وسأل عنه.
قال له السكّاف أنه، فى يوم عمله، يرى آلاف الناس يمرّون فى الشارع أمام دكانه، فينظر إليهم ويخاطب نفسه قائلاً: “الكلّ سيخلصون، وأنا وحدى سأهلك”. مما يعنى:
أ – أن احتمال الهلاك الأبدى ينبغى أن يكون ماثلاً بالنسبة إلى شخصياً ليشعرنى بخطورة الخيار الآن: “اَلْيَوْم، إنْ سَمِعْتُمْ صَوْتِه، فَلا تَقْسُوا قَلْوبَكُمْ”، ويحمينى من التهاون والميوعة والأستهتار.
ب – أنه ينبغى أن لا أتخذ من أحتمال الهلاك هذا سلاحاً أسلّطه على الآخرين (فإننى عند ذاك أضع نفسى خارج دائرة الحب وبالتالى أسير فى طريق الهلاك)، بلّ أن أقف من الآخرين موقف الرجاء الكامل الذى هو نفس موقف الله منهم.
وقد قال اسحق السريانى بهذا الصدد: “هذه وصية أعطيك إياها يا أخى، أن ترْجح الرحمة أبدًا فى ميزانك حتى تلك اللحظة التى تشعر بها فى ذاتك بالرحمة التى يشعر بها الله حيال العالم”.
عن هذا الموقف الأخير نقدّم شاهدًا هو عبارة عن قصّة جميلة من التراث الزهدى الرثوذكسى نختتم بها هذا المقال.
تروى القصّة أن أحد الرهبان الشيوخ كان له تلميذ متهاون فى سعيه الروحى. وقد توفى هذا التلميذ وهو لايزال مقيما على تهاونه. حزن الشبخ وأخذ يواصل الصلاة من أجل تلميذه. فتراءى له المسيح ذات يوم وقال له: لماذا تصلّى من أجل هذ، فى حين أنك تعلم أنه تركنى؟. ولكن الشيخ أبى إلا أن يستمر فى الصلاة. إلى أن تراءى له المسيح ثانية (وقد كانت هذه هى الرؤيا الصحيحة التى توصّل إلبها بعد أن توغّل فى الرحمة، فى حين أن الأولى كانت لا تزال مشوبة بالتصوّرات البشرية).
تراءى له وقال له: “أهكذا بلغ حنانك مستوى حنانى؟“. (يتبع)
Share this content:




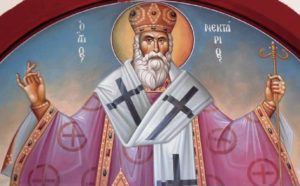





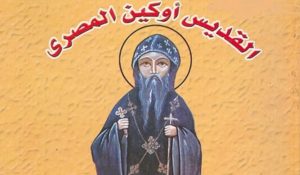























إرسال التعليق