الله والشر والمصير (1) كوستي بندلي
الدينونة والمصير – الجزء الأول
بين الرقاد واليوم الأخير
“هل هناك فترة زمنية تمتد بين اليوم الأخير (يوم الدينونة) وبين وقت رقاد الإنسان؟،
فى حال الإيجاب، أين تكون روح الإنسان خلال هذه الفترة؟.“
مقدمة
“اليوم الإخير“ هو نهاية التاريخ وتتويجه.
وعبارة “الأخير“ لها هنا بالضبط هذا المعنى المزدوج:
معنى “الانتهاء“ (كما فى قولنا هذا فلسى الأخير).
ومعنى “النهائى“ (كما فى قولنا: هذا رأيى الأخير).
أما “الرقاد“ فهو نهاية حياة فردية، كما أنه بمعنى من المعانى إضفاء صفة نهائية عليها.
فلابدّ إذًا من زمن يمتد بين الموت الفردى وبين نهاية التاريخ.
بين اختتام حياة فردية وبين اختتام المسيرة البشرية برمّتهأ.
مما يقود إلى التساؤل حول مصير الإنسان بين اللحظة التى تنقضى فيها حياته الراهنة وبين يوم الدينونة.
أولاً: أين تكون روح الإنسان فى هذه الفترة؟
 السؤال فى ظاهره يُعنى بتحديد مكان الروح بين الرقاد والدينونة.
السؤال فى ظاهره يُعنى بتحديد مكان الروح بين الرقاد والدينونة.
هذا ما يُستدلّ عنه من استعمال عبارة “أين“.
ولكن هذا الجوهر الإنسانى الذى نؤمن أنه يستمر فى الوجود بعد الموت الجسدى، هذا الجوهر الذى نسمّيه “الروح“ والذى هو عمق الشخص الإنسانى ونواته وخلاصته، هذا الجوهر لا تنطبق عليه مقاييس المكان التى يخضع لها كياننا المتجسّد الحاضر.
من هنا أن المقصود بالسؤال هو “حالة“ الروح بين لحظة الرقاد ويوم الدينونة.
فما هى هذه الحالة يا تُرى؟
1 – بالموت تسقط الحجب ويواجه الإنسان عاريًا نور الله:
وفى هذا النور الكاشف لأعماق أعماقه يستطيع تمييز حقيقته دون مواربة.
و“الدينونة“ أصل، إذا ما عدنا إلى العبارة اليونانية الواردة بهذا المعنى فى العهد الجديد KRISIS، إنما هى “التمييز“.
وعبر هذا التمييز يتحدّد مصيره.
والأحرى أنه يحدّده بنفسه:
فإما هو مع الله، فيكون مصيره فرح تلك المعيّة….
وإما هو متغرّب عنه، وبالتالى يكون قد جعل نفسه فى عذاب الغربة التى لا يمكن لشئ أن يلهبه عنه وينسيه إياها حينذاك.
2 – شئ من هذه المواجهة المصيرية:
يمكن أن يختبره المرء فى حياته الحاضرة عندما تتعرّى نفسه أمام الله فى لحظات مميزة تسقط فيها الأقنعة فتنكشف له جوانب حقيقته دون زيف وخداع، وعندما يتوّصل المرء إلى رؤية نفسه بالنظرة التى يراه بها الآخرون، فيطلّ عليها من الخارج إذا صحّ التعبير ويكتشف فيها جوانب كانت خافية عليه حتى ذلك الحين.3 – حالة الفرح التى تلى الرقاد مباشرة بالنسبة للإنسان الذى تتتوّج بالموت معيته مع الله، تلك الحالة يشير إليها العهد الجديد صراحة.
(فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ اَلْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي اَلْفِرْدَوْسِ) (لوقا 23: 43].
ولنا فى رسائل الرسول بولس أيضا شواهد على هذا الرجاء.
فقد ظن الرسول لأول وهلة أن نهاية الأزمنة سوف تكون قريبة وأمل بأن لا يذوق الموت بلّ يُخطف مع سواه من المؤمنين ليلاقى المسيح الآتى فى مجيئه الثانى:
(فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هَذَا بِكَلِمَةِ الرَّبِّ: إِنَّنَا نَحْنُ الأَحْيَاءَ اَلْبَاقِينَ إِلَى مَجِيءِ الرَّبِّ لاَ نَسْبِقُ الرَّاقِدِينَ. ثُمَّ نَحْنُ الأَحْيَاءَ الْبَاقِينَ سَنُخْطَفُ جَمِيعاً مَعَهُمْ فِي اَلسُّحُبِ لِمُلاَقَاةِ اَلرَّبِّ فِي الْهَوَاءِ، وَهَكَذَا نَكُونُ كُلَّ حِينٍ مَعَ اَلرَّبِّ) (1 تسالونيكى 4: 15، 17].
3- ولكنه أدرك بعدئذ أن هذا الأمل لن يتحقق بالنسبة إليه وأن لا بدّ له أن يمرّ بالموت:
ولكنه رأى فى الموت هذا طريقا للقاء الرب، فبدا له من جرّاء ذلك مرغوبًا ومحبّب، وإن كانت محبّته للمسيحيين الذين كان يرعاهم، تقوى على هذا الحنين وتحدو به إلى تفضيل البقاء معهم لفترة من أجل خدمة احتياجاتهم:
(لأَنَّ لِيَ اَلْحَيَاةَ هِيَ اَلْمَسِيحُ وَاَلْمَوْتُ هُوَ رِبْحٌ.
وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ اَلْحَيَاةُ فِي اَلْجَسَدِ هِيَ لِي ثَمَرُ عَمَلِي، فَمَاذَا أَخْتَارُ؟ لَسْتُ أَدْرِي!
فَإِنِّي مَحْصُورٌ مِنْ اَلاِثْنَيْنِ: لِيَ اِشْتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ اَلْمَسِيحِ. ذَاكَ أَفْضَلُ جِدّاً.
وَلَكِنْ أَنْ أَبْقَى فِي اَلْجَسَدِ أَلْزَمُ مِنْ أَجْلِكُمْ.
فَإِذْ أَنَا وَاثِقٌ بِهَذَا أَعْلَمُ أَنِّي أَمْكُثُ وَأَبْقَى مَعَ جَمِيعِكُمْ لأَجْلِ تَقَدُّمِكُمْ وَفَرَحِكُمْ فِي اَلإِيمَانِ) (فيليبى 1: 21-25].
لقد أدرك الرسول إذًا أن هناك لقاء بالرب يلى مباشرة انتقال الإنسان من الحياة الدنيا ولا ينتظر يوم الدينونة، وأن هذا اللقاء إنما يسمح برؤية الرب ويزيل الغربة التى لا نزال نعانى منها طالما نحن فى وضعنا الجسدى الراهن.
(لأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نُقِضَ بَيْتُ خَيْمَتِنَا الأَرْضِيُّ، فَلَنَا فِي السَّمَاوَاتِ بِنَاءٌ مِنَ اّلْلَّهِ، بَيْتٌ غَيْرُ مَصْنُوعٍ بِيَدٍ، أَبَدِيٌّ.
فَإِذاً نَحْنُ وَاثِقُونَ كُلَّ حِينٍ وَعَالِمُونَ أَنَّنَا وَنَحْنُ مُسْتَوْطِنُونَ فِي اَلْجَسَدِ فَنَحْنُ مُتَغَرِّبُونَ عَنِ اَلرَّبِّ.
لأَنَّنَا بِالإِيمَانِ نَسْلُكُ لاَ بِالْعَيَانِ.
فَنَثِقُ وَنُسَرُّ بِالأَوْلَى أَنْ نَتَغَرَّبَ عَنِ اَلْجَسَدِ وَنَسْتَوْطِنَ عِنْدَ اَلرَّبِّ) (2 كورونثوس 5: 1، 6-8].
4 – أمّا حالة العذاب:
فيشير إليها مثل الغنى ولعازر، ويعبّر عنها أبلغ تعبير بصورة العطش واللهيب.
فالإنسان إنما هو جوهريًا كائن تشدّه إلى الله رغبة محورية، هى رغبته التى لا تُقاوَم بالمطلق واللامتناهى.
فإذا رفض الله ليستأثر بذاته، فله فى هذه الدنيا من خلائق ما من شأنه أن يلهيه عن فراغه ويخدّر إحساسه بهذا الفراغ، إذ بوسعه أن يتوهّم – ولو كان لهذا الوهم حدود – أن المطلق الذى ينشده إنما هو كامن فى هذه وتلك من الخلائق التى تحمل بالفعل بعضًا من سماته منعكس عليها من ذاك الذى يمنحها الوجود، فيتصوّر المطلق الذى يتوق إليه كامنا فى الجسد والمال والجاه وما شابه ذلك.
ولكن الموت يُسقط الأقنعة ويُعرّيه من تلك المغريات التى كان يحاول أن يختبئ بينها متواريا عن مواجهة حقيقة ذاته وحقيقة رغبته كما حاول آدم أن يختفى بين أشجار الفردوس من مواجهة ربّه الساعى إليه ليخاطب قلبه
(وَسَمِعَا صَوْتَ اَلرَّبِّ اَلإِلَهِ مَاشِياً فِي اَلْجَنَّةِ عِنْدَ هُبُوبِ رِيحِ اَلنَّهَارِ فَاخْتَبَأَ آدَمُ وَاِمْرَأَتُهُ مِنْ وَجْهِ اَلرَّبِّ اَلإِلَهِ فِي وَسَطِ شَجَرِ اَلْجَنَّةِ) (تكوين 3: 8).
عند ذلك لا يبقى له، لا وراء عطشه الكيانى، إلا أن ينهل من خوائه الذاتى، فإذا به يلتهب عطشًا.
قد يتوصّل المرء المتوغل فى شرّه إلى التهرّب من هذه المواجهة الرهيبة حتى اللحظة الأخيرة محتميا منها بتحجّر قلبه وتبلّد ضميره.
ولكنها حاصلة لا محالة عندما لا يبقى للإنسان مناص من مواجهة حقيقته فى نور الله بعد اجتيازه حدود الحياة. (يتبع)
Share this content:




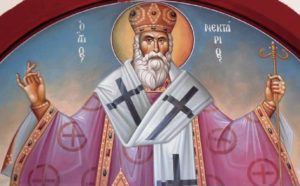





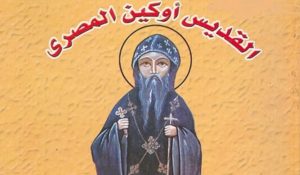























إرسال التعليق