القيم الأخلاقية التي ورثناها من الفداء _ الأب متى المسكين
 الفداء ليس مسألة موت وحسب لحصول الفدية.
الفداء ليس مسألة موت وحسب لحصول الفدية.
فالألم الذي عاناه المسيح بصورة مروعة قبل الصليب وعليه, يستدعي من داخل شعورنا التفكير في موضوع العدالة. فهنا البار يتألم من أجل الأثمة, هكذا ليعطي الله الدرس الذي يفتح العين المعميَّة والأذن المسدودة عند الخاطئ الذي يتعامى ويتصامم عن تقييم خطاياه, وكأن خطاياه تخصه وحده وهو حرُّ فيما يعبث ويُفسد:
فالله يقول للخاطئ:
+ أنت تخطئ, وأنا أدفع الثمن!!
+ أنت تُفْسِد وتلوَّث جسدك ونفسك وفكرك, وأنا أُطهر وأغسل وأقدس بدموع الألم والدم.
+ أنت تبيع حريتك للشيطان, وأنا أستردها لك بدق المسامير في جسدي ونزف الدم حتى إلى غُصَّة الموت!
كما يلزم أن ننتبه غاية الإنتباه أن المسيح في مواجهته للألم والظلم وضرب السياط وكل الهزء والسخرية التي جازها قبل الصليب وعليه, جازها بحساسية حقيقية وصادقة وواجهها بحزن بالغ وإنكسار قلبك: “نَفْسي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ!“ (مر 34:14). فهو لم يكن مجرد وسيط بين الله والناس بل ووسيط أيضاً بين الناس والله وحمل كل مشاعر الإنسان, الإنسان في نفسه وروحه وجسده. لقد كان حزن المسيح الحقيقي وإنكسار قلبه الصادق هو الجزء الأخطر والأكبر في عملية الفداء.
المسيح لم يقبل حكم الموت ملفوفاً في قرطاس مذهب, بل قَبِلَ موته علي أعشاب مرَّة بكل صنوف العذاب والهوان والفضيحة, حتى كسر العار قلبه.
إذاً, فليتيقظ فكر القارئ ليتعمَّق سر الفداء. فالفداء يحمل روح العدالة الصارمة تجاه الخاطئ الذي يغرَّمه بها حتماً قانون البر والقداسة والحق والعفة والطهارة, ولكن هذا كله حمله المسيح.
والفداء لا يحمل فقط توقيع عقوبة التعدي بكامل متطلباتها على المسيح وحده ليحملها وحده ليصير الفداء نافذ المفعول, هذا نقص معيب فئ مفهوم الفداء وعمله, إذ يتحتم على الإنسان أن يشترك شعورياً ووجدانياً اشتراكاً فعلياً وكأنها مناصفة مع المسيح في آلام الفداء لتسري فيه قوتها وفعلها المحرَّر, وحينئذ ينال الفداء حقيقة وفعلاً.
والمسيح قَبِلَ في شعوره وإحساسه ووجدانه رَبْقة هذه الآلام والعذابات وكل ما لابسها من هوان وفضيحة وعار, ليس كأنها وُضعت عليه ليحملها, بل هو الذي سعى إليها وطلبها, وسعى إليها عن سرور ورضى, وطلبها باهتمام ووعي لانها كانت صميم عمله ورسالته. وهذا أيضاً من صميم الفداء.
وعلى هذا المستوى يتحتم أن نعي الفداء نحن أيضاً. فالصليب وعاره وكل ما يحمله من آلام وضيقات لا يمكن أن نحسبه أنه أمر وُضع علينا لنحتمله, بل يتحتم لكي يصير الصليب قوة للفداء حقاً أن نسعى إليه بسرور ونطلبه كرسالة لأنه لم يَعُدْ صليب المسيح بل صليبنا الشخصي.
والمسيح نجح نجاحاً مذهلاً في احتماله لكل صنوف العار والهوان, وأحتمل الآلام احتمالاً شجاعاً بطولياً, لماذا؟ قوته وسلطانه ومجده, لأنه أخذ شكل العبد عن لياقة كاملة, وأحنى ظهره عن جدارة الاتضاع الحقيقي, هذا هو العامل الاول, أما الثاني فكان الحب الإلهي الذي كان يحرق قلبه ووجدانه ويستأسر كل مشاعره من نحو كل الذين عزم أن يقتنصهم من قبضة الشيطان ويفك أسرهم ويستردهم لكرامة أولاد الله. التجرد والحب معاً, بهذين احتمل ألم الفداء.
وبهذا أيضاً يتحتم علينا أن نعرف أن الفداء تحت صنوف الهوان والأضطهاد والآلام بكل أنواعها, التي هي صبغة الصليب الحتمية, لا يمكن أن نستوعبه إلاَّ من خلال هذين العاملين, التجرد والحب.
إذاً, فليس الفداء يا عزيزي القارئ قضية لاهوتية صماء أو خرساء نفهمها أو ندرسها كمقولة تأتي فعلها من تلقاء ذاتها. الفداء يتكلم بأبلغ وأفصح مشاعر التراجيديا, أي المأساة, ولكنها مأساة إلهية انتهت بأعظم انتصار حققه الله بنفسه لحساب الإنسان, فدم الفداء يتكلم ويثمر فينا بالحب في أشد الألم, بالأنتصار في أقسى انكسار, بالمجد في عمق الهوان.
لغة الفداء يفهمها قلب الإنسان الذي حطمته الخطية, ويفسرها جيداً مَنْ ذاق أسر الشيطان. لغة الفداء هي قلب إنجيل البشارة النابض كتبها المسيح بدمه لتكون لغة الكنيسة التي تُلقَّنها لكل من خلعوا ثيابهم ليُدفنوا مع المسيح تحت الماء لينالوا فضل المسيح والمسيحية.
فبولس الرسول استمد كل تعاليمه الروحية من الفداء لنفسه أولاً ثم للآخرين ككارز بنعمة المسيح ليؤسس بها بشرية جديدة لها أخلاق المسيح وروحه وفكره التي بها نزوله من السماء وإتخاذه شكل العبد ليضع لنا هذا الفداء.
+ فالمحبة: التي ينادي بها بولس الرسول لتكون محور أخلاقنا الجديدة ومنبع فكرنا وتصرفاتنا هي المحبة التي أحبنا بها المسيح والتي هوَّنت عليه فداحة آلام وموت الفداء! (أف 1:5-2).
+والطاعة: التي يسوقها علينا بولس الرسول لكي نعيش في ظلها الأمين هي ذات طاعة الأبن للآب, طاعة المسيح لمن أرسله ليكمل بها ذبح نفسه!! أيه طاعة كانت وأية طاعة ينبغي أن تكون! (في 8:2).
+ والتواضع: الذي يبثُّه بولس الرسول فينا ليكون هو طبيعة أخلاقنا الجديدة لا عن تمثيل ولا قسر, بل عن مسرة المشيئة كما سُرَّ المسيح أن ينحني تحت ضاربيه, ويسلم الوجه ويستعذب الإهانة والشتيمة, ويرضى أن يُساقَ كالشاة حاملاً صليبه ليكمل ما اشتهاه أبوه وما اشتهى هو, أن يفدي الخطاة!! (في 7:2-8).
+ وإنكار الذات: الذي أراد بولس الرسول أن يجمَّل به أخلاقنا, هو عدم إرضاء المسيح لذاته (رو 3:15), إذا وهو الإله أنكر ما هو لذاته من مجد, وحجب عن نفسه كل عظمة وبهاء جوهره, ليظهر بذات عبد كسير مرفوض من الناس ومذلول, ليستطيع هو ويستطعون هم أن يقدموه على الصليب ذبيحة وفدية.
+واحتمال المشقات: (2تي 8:1) التي راى بولس الرسول أنها ينبغي أن تكون سمة من تجندوا لحساب المسيح فهي الصورة التي لمعت في ذهن القديس بولس عن المسيح, كيف واكبته منذ أن نادى بالخلاص حتى أكمله على الصليب.
+وهكذا الصبر: (2تس 5:3) وقبول الضيقة بفرح (1تس 6:1) يسوقهما علينا القديس بولس من المسيح رأساً.
وبولس الرسول يتجاوز مجرد التشبُّه بفضائل الفداء التي أكمل بها المسيح الفداء, بل ينتقل إلى مستوى الشركة والامتلاك, لأن المسيح في لاهوت بولس الرسول ليس مجرد نموذج نتشبَّه به بل ينبوع يفيض لنمتلئ منه. فليست الفضائل التي أكمل بها المسيح الفداء معروضة علينا, بل الفداء ذاته الذي أكمله المسيح أساساً ليهبه لنا, فهو لا يهب لنا كيف احتمل الآلام أو كيف مات, بل يهب لنا شركة كاملة واتحاداً حقيقياً في الآلام والموت اللذين أكمل بهما الفداء. كذلك فليس هو اتحاداً تصورياً ذلك الذي يعطيه لنا, بل هو اتحاد حقيقي بالروح بسر إلهي له ثماره وأعماله التي هي أقصى برهان لتحقيق عمله ووجوده. فالذي يشترك في موت المسيح ينال فعل الموت وموته عن العالم وشهواته وأمجاده, وبالحري فالذي اشترك في الآلام التي أدَّت إلى الموت الحقيقي عند المسيح نراه وهو فَرِحُ في ضيقاته وآلامه مستهيناً بكل صنوف الأضطهاد والمذلة شاكراً مبتهجاً كمن أكمل العقوبة مع المسيح.
من هذا نفهم كيف يحث بولس الرسول قديسيه في كل كنيسة أن يحتملوا الضيقات بفرح وأن يصبروا بشكر في آلامهم: “وَقَبِلْتُمْ سَلْبَ أَمْوَالِكُمْ بِفَرَحٍ.“ (عب 34:10), بل نفهم لماذا كان هو وعلى الدوام فرحاً في آلامه وضيقاته. فهذه كلها ليست فضائل الفداء بل مفاعيل الفداء الذي وهبه لنا المسيح بكامل أعماله السابقة واللاحقة على الصليب ومعه ثماره. من هذا نفهم لماذا يفتخر بولس الرسول بصليب المسيح, فهو كما يقول أنه له “قُوَّةُ اللهِ لِلْخَلاَصِ“ (رو 16:1). فالصليب بل و “كلمة” “الصليب“ في حد ذاتها تحمل “قوة” الفداء الذي أكمله المسيح, علماً بأن الفداء الذي أكمله المسيح لنا يشمل القوة الإيجابية للموت والقيامة معاً بل والحياة والتبني, كما يشمل القوة السالبية بغلبة الخطية والموت والعالم وكل قوات الظلمة.
لذلك, فالفداء في لاهوت بولس الرسول سواء بالتعليم المباشر أو من واقع سلوك بولس الرسول نفسه هو مصدر غنى الحياة الروحية الجديدة في المسيحية بكل فكرها وسلوكها وأخلاقها. ومرة أخرى نقول إن الفداء الذي أكمله المسيح ليس نموذجاً نأخذ منه, بل قوة نحصل عليها ونمتلكها, نغتني بها وننفعل بها وتفعل فينا, لأن من ذا الذي يستطيع أن يحتمل الآلام والأضطهاد والتجريد والمذلة, ويحتملها بفرح, بمجرد أن يتمثل بالمسيح أو يحاكيه؟ أو مَنْ ذا الذي يستطيع أن يموت عن العالم أو يميت أعضاءه على الأرض بمجرد أن يسمع الوصية ويعطيعها أو أنه يتمثل بالمسيح ويحاكيه؟
يلزم أن نفهم أن الفضائل ليست فضائل جسدية أو حتى بشرية!!! إنها فضائل الفداء, والفداء عمل إلهي بشري معاً, لذلك قيل أن الصليب هو “قُوَّةُ اللهِ لِلْخَلاَصِ“ (رو 16:1), والقيامة قوة حياة.
فإذا كان بولس الرسول يحث المؤمنين أن يعيشوا بفضائل المسيح فعلى أساس امتلاك المسيح بقوة موته وقوة قيامته وحياته, وامتلاك المسيح تمَّ لنا بالفداء أي بكامل موته وقيامته!! فبموته نستطيع أن نعمل كل أعمال موت المسيح في أجسادنا ونفوسنا وتجاه العالم, وبحياته نستطيع أن نعمل بحياته أعمال الله والحياة والسلوك بالروح.
———————————–
كتاب بولس الرسول (الفصل الخامس) _ الأب متى المسكين ص 273-276
—————–
♥ تعليق واجب:
فضائل وأخلاق الفداء هي شركة الطبيعة الأنسانية في التجسد والفداء بلا إفتراق ولا أمتراج ولا تغيير في أصول الأجناس, لأنه لا شركة لنا في ثمار الفداء إلا بظهور أخلاق الفداء في حياتنا, لأنه لا شركة للظلمة مع النور, ولهذا لا يمكن على الإطلاق فصل الفداء عن ثمار الفداء من بعد وحدة التجسد في المسيح يسوع, وهكذا لا يمكننا أن نفصل بين الفداء كعمل إلهي عن ثماره .. التى هي القيم الأخلاقية التي لنا في تجسد المسيح!!
لأن شرح الفداء كعمل إلهي خالص لا يشترط التوبة والتغيير الأخلاقي هو شرح عقيم!! بل هو الأعتراف الضمني بأن التجسد قد أصابه عطب, فعجز عن تغيير حياة الناس الأخلاقية!!
ولهذا السبب ذاته يكتفي الغربيين بعمل المسيح وحده دون أشتراط الشرط الضروري للخلاص الذى هو … تغيير حياة الناس!!!! وهذا أعتراف واضح بأنفصال شطرى التجسد, ليكمل المسيح عمله الخلاصى وحده, دون شرط شركة الطبيعة البشرية في هذا التغيير!! وهكذا بالضبط تعطلت صناعة القديسين في كل الغرب, حتى أصيبت الكنيسة بالعقم الكامل!!!
ولهذا فقد أعتبره أبونا متى شرحاً معيباً للفداء والخلاص: (هذا نقص معيب فئ مفهوم الفداء وعمله, إذ يتحتم على الإنسان أن يشترك شعورياً ووجدانياً اشتراكاً فعلياً وكأنها مناصفة مع المسيح في آلام الفداء لتسري فيه قوتها وفعلها المحرَّر, وحينئذ ينال الفداء حقيقة وفعلاً.)
لذا تعتبر هذه رسالة واضحة تماماً لعصر الإصلاح الذي فتت الحياة المسيحية المستقيمة, بحسب فلسفة لاهوتية ليس لها سند التذوق والصليب, لتقر وتشرع بتجزئة معانى المصطلحات والألفاظ, كأساس لشرح عقيم لا يلد بنيين, ليتم وعن عمد غير صالح, بتر العمل الإلهي الكامل الباقي للأبد, عن أعمال الإنسان الزمنية الزائلة, وتباعاً فُصِلَ الإيمان عن اعمال السلوك المسيحي الحقيقي.
فإلى متى سنظل مسحورين سجناء لفلسفة لاهوت عصر الإصلاح, التي لم يأتي بأيه إصلاح على الإطلاق, بل جاء فقط بالدمار والخراب والتفتيت والتشتيت والانقسام والإنحلال الخلقي والأسري أيضاً!!
Share this content:




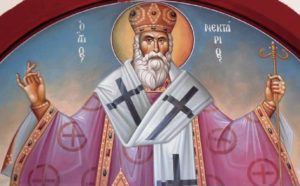





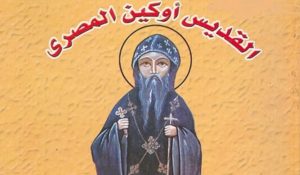























إرسال التعليق