رسالة القديس يوحنا ذهبي الفم ـ السابعة ـ إلى “أولمبياس”
ملحوظة هامة قبل أن نبدأ في عرض الرسالة:
تنتشر على صفحات الشبكة الإلكترونية نسخة للرسالة السابعة منقولة من ذات مصدر الترجمة الذي نقلنا عنه, وهو كتاب “يوُحَنّا الذهبيّ الفم في الكهنوت ــ أحاديث عن الزواج ــ الرسائل إلى أولمبيا” تعريب الأسقف أستفانوس حَدّاد ــ منشورات النور, إلا أن مواقع التواصل الأجتماعي لم تكن أمينة في نقلها لأمانة التسليم, فقد قدمت أختصاراً مخلاً للمعنى والهدف معاً عما ما قدمته منشورات النور من ترجمة الأسقف أستفانوس حداد, فقد حُذفت الكثير من التعبيرات الهامة, بل وأجزاء كاملة أيضاً, والتي تصف أضطهاد اليهود للمسيح حتي الصليب, وأضطهاد بولس الرسول من السلطان الزمني, وأستشهاد أستفانوس الشماس على يد أعداء خارجين عن الكنيسة …. إلخ.
وذلك بغرض الإيحاء بأن القديس يوحنا كان مشتكياً إلى “أولمبياس” مما قد أصابه من أضطهاد وظلم السلطانة “ثيؤدوسيا” له, وللإيحاء بأن العواصف تعصف بالكنيسة من الداخل! لذا تم حذف الأجزاء التي فيها يضم القديس آلامه الشخصية مع آلام “أولمبياس” الحزينة لتشجيعها وتضميد جراحها, ونحن هنا لا ننكر الظلم الذي قد وقع على القديس يوحنا فم الذهب, ولكنه ليس من الأمانة العلمية أستخدام هذا لتغيير هدف القديس نفسه من رسائله السبعة عشر التي قد أرسلها لتعزية “أولمبياس” الرقيقة, لتستخدم المصطبة الإلكترونية ظلم السلطان الزمني للقديس يوحنا بطريقة خاطئة, لأخفاء هدف الرسالة الأصلي, وهو تعزية “أولمبياس” الحزينة جداً لدرجة اليأس بسبب نفي القديس يوحنا ذهبي الفم.
اللون الأزرق يشير إلى كل الفقرات المحذوفة في النسخة المتداولة إلكترونياً.
رسالة القديس يوحنا ذهبي الفم السابعة إلى “أولمبياس”
 سأمضي … إذاً في محاولة تنظيف جرحك, وتبديد الظلمات التي تغطي نفسك. إن ما يطرحكِ في العجز واليأس والعذاب إنما هي العاصفة الرهيبة السوداء التي تقتحم الكنيسة لتلفها بليلٍ حالك، وظلماتٍ بعضها فوق بعض تتكاثف على الأيام لتتسبب في إغراق الكثيرين، وتنشر الدمار على وجه الأرض. أنا أعرف هذه العاصفة وأعرفها جيداً، وليس من ينكرها. بل إذا شئتِ فسأحاول أن أرسم ببعض الصور الأخاذة، زمن المأساة هذا الذي نجتازه.
سأمضي … إذاً في محاولة تنظيف جرحك, وتبديد الظلمات التي تغطي نفسك. إن ما يطرحكِ في العجز واليأس والعذاب إنما هي العاصفة الرهيبة السوداء التي تقتحم الكنيسة لتلفها بليلٍ حالك، وظلماتٍ بعضها فوق بعض تتكاثف على الأيام لتتسبب في إغراق الكثيرين، وتنشر الدمار على وجه الأرض. أنا أعرف هذه العاصفة وأعرفها جيداً، وليس من ينكرها. بل إذا شئتِ فسأحاول أن أرسم ببعض الصور الأخاذة، زمن المأساة هذا الذي نجتازه.
إني أرى بحراً هائجاً من سطحه إلى أعمق أعماقه، وأرى جثث البحارة بعضها عائماً فوق المياه، وبعضها يغرق في اللجج، وألواح السفن مبعثرة على سطح اليم، والأشرعة ممزقة، والصواري مكسرة، والمجاذيف منتزعة من أيدي المجذّفين، والبحارة جالسين على بقايا الجسور, قابضين بأيديهم, بدل المقود والمجاديف, ركبهم التي يشدونها نادبين عجزهم، ومطلقين الصراخ، مسمعين نحيبهم، وليس بوسعهم شيء سوى البكاء. في هذا الجو لا ترى أرض ولا سماء، وكل ما هنالك ظلمات كثيفة حالكة تغطي كل شيء بضباب كثيف أسود لا يميز فيه الإنسان حتى أهله، ولا يسمع شيء سوى ضجيج اللجج وصرخات البحارة القاسية التي يتوجهون بها إلى الغرقى من كل جهة.
ولكن بأية عبارات أتعلق لأتمكن من أن أصف ما هو مستحيل وصفه؟ لقد اتيتُ بتصوير لما هو من آلام هذه الدنيا، وآلامنا هي فوق ما يعبّر عنه بالكلام، وإذا التمست لها صوراً يفوتني التعبير. ولكن ومع هذا، فمشهد آلامنا الحاضرة لا يمنعني من أن أتأمل بأيام أفضل. فلدينا ربان لا يحتاج إلى مهارة الصنعة ليتجاوز الإعصار، وحركة منه واحدة تكفي لتهدئة العاصفة.
وإذا رأيت أنه لا يفعل ذلك من البداية وعلى الفور، فذاك من حكمته ألا يوقف السوء في انطلاقه، بل يتركه ينتشر ويتعاظم. وعندما يقترب الهلاك والدمار وحين يأخذ اليأس بكل النفوس، يأتي بعجيبة من عنده تدهش الرجال وتسطع بها قدرته بعد أن يكون قد استنفذ الصبر من عبيده.
وإذن فلا تدعي نفسكِ تضطرب يا أولمبيا. ليس من محنة في الوجود خطيرة ومخيفة سوى محنة واحدة هي محنة الخطيئة. هذا ما كنتُ اردده أمامك دائماً. وكل ما عدا الخطيئة إنما هو وهم. أو سمّهِ ما شئتِ: المؤامرات، والأحقاد، والخيانات، والوشايات، والمسبّات، والاتهامات، والمصادرات، والمنافي، والمجازر، والحرائق، والغرق، كل هذه الأمور وقتية عابرة لا تصل إلاّ إلى أجسادنا المائتة وتترك الأنفس المستعدة سالمة من الأذى.
إن أفراح الحياة الحاضرة وأحزانها هي غير ذات أهمية. والقديس بولس الرسول لا يقول عن هذه وعن تلك سوى كلمة واحدة: “الأمور التي ترى هي وقتية” (2كو 18:4). لماذا نخشى مما لا نراه إلا لحظة عابرة ويمر كمياه النهر؟ تلك هي أفراح الحياة الحاضرة وأتراحها. وهناك من الأنبياء من شبه بالعشب، بل بزهر العشب أيضاً، كل سعادة الإنسان، ليس فقط الغنى والملذات والقدرة والأمجاد بل كل ما يعجب به الناس. “كل مجد بشري هو كزهر العشب” (أش 6:40). ليس من شك في أن الشقاء ثقيل وصعب الاحتمال، ولكن لا نعطه كثيراً من الأهمية. فلنتذكر أن أشعياء النبي لا يعطي المسبات والعسف والظلم والتعيير والهزء ومؤامرات الأعداء من الأهمية أكثر مما يعطي الثوب البالي الذي قرض العث صوفه: “لا تخافوا من شكايات الناس، ولا تضربوا لظلمهم لأن كل ذلك سيبلى كالثوب وسيصبح كالصوف فريسة للعث” (أش40 :7-8).
لا تدعي إذن نفسكِ تضطرب من أجل الأحداث التي حدثت. لا تلتمسي لكِ سنداً لدى فلان أو فلان، ولا تركضي وراء الظلال (سند الرجال ليس إلا كالظل). وليكن يسوع وحده، يسوع الذي تعبدينه، ليكن ملجأكِ وسندكِ. هو وحده يستطيع، بحركة واحدة وفي لحظة واحدة، أن يعيد الهدوء. ستقولين أنكِ رجوته ولم تحصلي على شيء. ولكن تذكري ما كنت قد قلته لكِ، أن الله ليس من عادته أن يأتي فوراً ليهدئ الأمواج، بل يتركها ترتفع، ويترك الإعصار يتعاظم. وعندما لا يبقى أمل، عندئذ يحضر فجأة ويُقر الهدوء، ويعيد إلى الناس طمأنينتهم المفقودة.
وليس يحقق فقط رجاءنا وانتظارنا بل يزيد على ذلك أكثر مما كنا نرجو. هذا ما يقوله بولس الرسول: “هو الذي يعطينا فوق ما نطلب وفوق ما نتصور” (أف 20:3).
بداية الأمر أن يطرح الفتية الثلاثة في أتون النار. انه لم يفعل شيئاً، وذلك لكي يغدق عليهم مكافأة أعظم. تركهم يسعرون الأتون حتى صار لهيبه عالياً جداً. ترك الملك يهيج غضبه كالنار تركهم يُوثقون أيدي الفتيان وأرجلهم وجعلهم يطرحونهم في النار المتقدة. وكان أنه عندما فقد المشاهدون أملهم من نجاة الفتية ظهرت يد الرب، وبعجيبة، جعلت قدرته تظهر ببهاء. فما هو أن أخذتهم النار فجأة بأيد موثقة حتى انحلت ربط الأبرياء وسقطت من أيديهم. وكان الأتون يتحول إلى بيت صلاة، والماء إلى ندى مرطب، وألسنة اللهيب إلى قصر أفخم من قصر الملك. والنار التي تفترس كل شيء، النار التي تغلب الحديد والحجارة ولا يثبت أمامها شيء، لم تستطع أن تلمس شعرة من رؤوسهم، وهناك يقف جوق الفتية الثلاثة القديسين لينشد نشيدهم داعين كل الخليقة إلى أن تضيف صوتها إلى أصواتهم. وفي تسبيحهم الشكري كانوا يباركون الله الذي فكّ وثاقهم، ويهنئون بعضهم بعضاً على أنهم ألقوا في النار، وعلى أنهم أُخذوا من بلدهم، واقتيدوا إلى السبي محرومين من الحرية، تائهين بدون وطن، وبدون أهل، مجبرين على أن يعيشوا في أراض غريبة، وشعب بربري، ولم يبق لأعدائهم إلاّ أن ينفذوا فيهم كل شرهم. (وما أكثر من أن يهلكوهم), وكان يجب أن يترك لهؤلاء الأبطال أن يمضوا إلى أبعد حدود انتصاراتهم، وأن يحملوا أكاليلهم، وأن يجمعوا جوائز نصرهم ولا يفقدوا شيئاً من هذا النصر والمجد.
وماذا بعد؟ ألّمْ نرى ذلك الملك الطاغية الذي أوقد أتونهم وأسلمهم لمثل ذلك العذاب يصير المحتفِل الكبير بقدسينا الأبطال، ويغدو بطل تمجديد القدرة الإلهية الفائقة؟ فقد وجه رسالة إلى كل المسكونة مليئة بالحماس والإعجاب بذيع فيها قصة العجب الحادث. صار شاهداً لا يتراجع للعجيبة التي لم يُسمع بمثلها والتي اجترحها الله تعالى. ذلك أنه عندما يشهد العدو بالعجب، فتأكيده لا يمكن أن يوضع موضع الشك حتى ولا من جانب الأعداء الآخرين.
ألا ترين مهارة العناية الإلهية وحكمة الله وأسلوبه العجيب في توجيه الأحداث، وبنفس الوقت تفرده في العجب والتصرف، واستهدافه صلاح البشر؟ فلا تضطربي، ولا تتعذبي لأجل كل ما يحدث. ولا تنفكي تشكرين الله وتمجدينه، وتفزعين إليه، وتدعينه وتصلين له. وليكن لك أن تتمثلي كل أنواع الإضطرابات والانقلابات والعواصف فلا يعذبك شيء منها. ما من صعوبة تقف أمام المعلم حتى ولو ظهرت لك كل الأشياء سائرة إلى الغرق والهلاك.
كل شيء مستطاع عنده. يستطيع أن يقيل العاثرين من عثراتهم، ويعيد الضال إلى سواء السبيل، وأن يسوّي أوضاع المنحرفين، وأن يعفيهم من خطاياهم ويجعل الساقطين في ألف خطيئة أنقياء. ويستطيع أن يقيم الموتى، وأن ينهض هياكل رفاتهم ويحييها من البلى، ويهبها جمالاً أبهى من الأول. ولعمري إن الذي أخرج الخليقة من العدم إلى الوجود، وأعطى الحياة لمن لم تكن له قبلاً حياة، يستطيع بالأحرى أن يعيد إلى ما كان عليه وضعاً كائناً، وضعاً كان قد خلقه.
ولكن قد تقولين لي كم من النفوس تهلك! وكم من النفوس تتشكك وتعثر! وكثير من هذا البلاء كان قد حدث قبلاً، وكل شيء عاد إلى حاله فيما بعد. فما بالك تضطربين، وما بالك تتعذبين، إذا كان هذا قد أخرج إلى المنفى، وذاك حل في محله؟
المسيح صُلب في حين أُنعم على القاتل باراباس بإطلاق سراحه. والجمهور الشقي كان يصرخ مريداً أن يخلص القاتل المجرم بدلاً من مخلصه الحقيقي، والمحسن إليه فعلاً. فكم من النفوس تشككت في ذلك الحين بسبب ذلك الموت؟ وكم من الناس يتشككون في هذا حتى أيامنا الحاضرة؟
ولكن فلنتناول سيرة مخلصنا من بدئها. فإنه ما ان ولد حتى اضطُر إلى تغيير بلده. وذهب إلى المنفى. كان في المهد حين ذهب مع كل العائلة إلى أرض غريبة، إلى بلد بربري، في سفر طويل جداً.
أضف كل ما تبع ذلك من أحداث: جداول الدم المسفوح في مقتل الأطفال الأبرياء في تلك المجزرة الرهيبة، كل أولئك الأطفال الذين قتلوا بغير شفقة كما لو كانوا في معركة وفي ساحة الحرب. كانوا ينتزعون عن أثداء أمهاتهم ليسلموا إلى السيف. والسيوف كانت تغوص في حناجر طرية مليئة باللبن. هل يمكن أن نتصور مأساة أفظع من هذه المأساه؟ هذا ما لم يكن يتحرّج من فعله ذاك الملك الذي كان يطلب أن يهلك المسيح. والله، في صبره، كان يترك مثل هذه المأساة المروّعة أن تتم، وأن تسفك تلك الدماء البريئة. كان يدعهم وما فعلوه وهو قادر على أن يمنعهم. وهذا إنما كان لسر في حكمته حتى أظهر مثل هذه الأناة.
ومن بعد عودة المسيح من مصر، وبعد أن تهيأت له أسباب الدعوة في اكتمال السن وكمال النعمة والقامة، شهد حرباً تولع ضده، من كل جهة. فهوذا تلاميذ يوحنا الذين كانوا حاسدين له، ومأخوذين بالغيرة منه، على الرغم من شهادة سيدهم له: “هوذا الذي كان معك في عبر الآردن يعمد وكل الناس تتبعه” (يو 26:3). تلك لهجة قوم وَخَذَهم الحسد، وأخذتهم الغيرة حنى تأكّلتهم شهوتها المشؤومة. وهذه الغيرة أيضاً هي التي قادت أحد تلامذة يوحنا أنفسهم إلى مباحثة اليهود في موضوع التطهير وإلى المقابلة بين المعموديتين، معمودية يوحنا ومعمودية تلاميذ يسوع (يو 25:3).
ولما بدأ يجترح العجائب فكم أثارت عليه عجائبه من التجاديف والإتهامات الكاذبة؟ البعض قالوا عنه أنه سامري وبه شيطان (يو 48:8)، والآخرون رموه بالتدجيل والتضليل: “ليس هذا من الله وإنما هو يضل الشعب” (يو 12:7). ورماه غيرهم بالسحر والشيطنة: “باسم رئيس الشياطين بعلزبول يخرج الشياطين” (مت 34:9).
وكانوا يرددون عنه أموراً أخرى فظيعة وكانوا يقولون أنه منافق، شرهُ، أكول، سكير ومرافق السكارى والخطأة، “جاء ابن الإنسان إلى الأرض يأكل ويشرب فقالوا عنه انه إنسان يأكل ويشرب ويعاشر الخطأة والعشارين” (لو 34:12). وحينما رأوه يتكلم مع امرأة زانية قالوا عنه أنه نبي كاذب: “لأنه لو كان إنساناً نبياً لعرف مع من يتكلم” (لو 39:12). وهكذا كانوا كل الأيام يتحاملون عليه ويضمرون له الشر في أنفسهم.
وليس اليهود وحدهم هم الذين كانوا يثيرون عليه الحرب، بل حتى أولئك الذين كانوا يُحسبون أخوة له لم تكن عندهم نية حسنة عنه ولا فكرة حسنة، وكان أقرب أقربائه يناوئونه ويضطهدونه بلا انقطاع. يمكنك أن تستخلصي هذه الأمور مما ذكره الإنجيلي: “أن أخوته أنفسهم لم يكونوا يظنون به حسناً” (يو 5:7).
انت تتكلمين عن أشخاص كثيرين قد تشككوا بالأحداث الحالية، وخسروا إيمانهم. فافتكري بتلامذة المسيح جميعاً الذين تشككوا أيضاً وأضاعوا إيمانهم في وقت آلامه. أحدهم خانه وسلمه والآخر أنكره، والبقية هربوا واختفوا. ولما هرب الجميع اقتيد وحده مقيداً إلى العذاب والصلب.
وكم وكم من أناس تشككوا بعد أن رأوه قبل قليل يجترح العجائب, يقيم الموتى, ةيبرئ البرص, ويطرد الأرواح الشريرة, ويكثر الخبز ببركته ويجترح جماً من العجائب والمعجزات؟! كم وكم تشككوا وغيروا فكرتهم عنه في وقت الصلب حين رأوه وحيداً مقيداً منقاداً إلى العذاب ومحاطاً بجنود سافلين تتبعه عصابة كهنة اليهود صارخين ونابحين خلفه, وحيداً مسلماً إلى أعدائه, وحيداً مع الجلاد المعتز بسوطه!
كم وكم من أناس غيروا رأيهم فيه حين رأوه يصفع بالسياط! كثيرون وكثيرون! ويفترض أن يكون هناك جموع غفيرة, لأن ذلك حدث أثناء عيد من أعظم أعياد السنة كان يجمع كل يهود العالم في أورشليم, وفي أورشليم العاصمة, وفي وضح النهار, كانت تجري مأساة هذه الجريمة. ومن هذه الجماهير كان كثيرون ممن رأوا المسيح وتبعوه وأرتدوا عليه في ذلك اليوم حين رأوه مقيداً مجلوداً بالسياط مخضباً بدمه, يستنطقه القضاة من غير أن يكون إلى جانبه واحد من تلاميذه.
أجل ماذا عليهم أن يقولوا أمام هذه المشاهد المختلفة التي كانت تتبع بعضها بعضاً متلاحقة أمام أعينهم وعلى سمعهم؟ هنا يكلّل بأكليل من شوك, وهناك يلبسونه ثوب الجند الأحمر, وأثناء ذلك يضعون في يده قصبة وينحنون أمامه ليعبدوه ولم يبقَ نوع من الهزء والسخرية لم يفعلوه به!
فأي انقلاب في أفكارهم! أي اضطراب, وأيه بلبلة حدثت في أنفسهم حين رأوه يتقبل اللكمات ويسمعهم يقولون: “تنبأ أيها المسيح من الذي ضربك!”, حين رأوه داخلاً وخارجاً, ذاهباً وعائداً, يقاد إلى هنا, ويقاد إلى هناك, كل النهار بهدف السخرية والشتائم والضحك على مسرح أورشليم الواسع؟
ماذا كان عليهم أن يفتكروا حين رأوا عبد رئيس الكهنة يصفعه, وحين رأوا الجند يقتسمون ثيابه, ويقودونه إلى الصليب عارياً حاملاً في ظهره آثار السياط والضرب ومعلقاً أخيراً على الصليب؟ ما من شئ أستطاع أن يلين قلوب أولئك الوحوش البرية. بل كان توحشهم يزداد, وهول المأساة يتعاظم كل ساعة, والسخريات تبلغ حدها في قولهم: ” آه يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام! خلص آخرين ونفسه لا يقدر أن يخلصها! إن كنتَ أنت ابن الله فأنزل عن الصليب لنرى ونؤمن!” (متى 40:27-42). وحين كانوا يطلقون عليه الشتائم الفظيعة, أحضروا له أسفنجة مغموسة بالخل لكي يطفئ عطشه, وكان اللصان أيضاً أنفسهما يجدفان عليه.
وأراني لا أستطيع أن أمنع نفسي من العودة إلى اللص الأول الذي تكلمت عنه، إلى باراباس، إلى هذا اللص الهائل، هذا السفاح الرهيب(ألا يرعبنا مجرد التفكير بهذه الظلامة المنكرة؟)، الذي فضل اليهود إطلاقه بدل المسيح. كان عليهم أن يختاروا بين المسيح والمجرم ففضلوا المجرم. وليس الأمر عندهم أمر صلب المسيح فحسب، بل يقصدون أن يمحوا ذكره. لذلك قصدوا أن يفهموا الجمهور أنه أكثر من مجرم، وأن يجعلوه خارج القانون والشريعة حتى لا تأخذ الناس فيه شفقة، ولا يشفع فيه بهاء العيد ورونقه. وكل ما فعلوه إنما فعلوه بهذا المقصد، أن يمحوه من ذهن الجمهور ولهذا أيضاً علقوه بين مجرمين. وأنتِ تعلمين أن حقيقته لم تختفِ لأجل هذا بل ظهر من هذا التصرف ظفره الباهر.
وأية شكاية كاذبة لم يقدموها للسلطة الحاكمة؟ “من يجعل نفسه ملكأً يقاوم سلطة قيصر” (يو 12:19). هذا ما عزوه إلى من لم يكن له مكان يسند إليه رأسه. ألم يشكوه بالتجاديف؟ لقد مزّق رئيس الكهنة ثيابه وهو يصرخ: “لقد جدف ! فما حاجتنا بعد إلى شهود؟”
أما موته! وماذا أقوال عن موته؟ ياله من موت تعيس رهيب! موت أشقى المحكومين! موت الملعونين! الموت المهين جداً! الموت المخصص لأكبر المجرمين, لمن جثته كأنها توسخ التراب, ومن لا يستحق أن يلفظ نفسه على الأرض, بل كان يجب أن يلفظ أنفاسه بين السماء والأرض!
والجثمان, حتى الجثمان, لم يكن في سلطة أحد أو من حق أحد أن يأخذه. كان يجب أن يطلب الجسد طلباً من بيلاطس. ومن الذي يدفن؟ رجل غريب لم يكن من ذوي قرابته, ولا من تلاميذه, ولا من الذين شملهم إحسانه, ولا من الذين نعموا بصحبته, ولا من يدينون له بخلاصهم: كل من ذكرنا كانوا قد هربوا وأختفوا.
ولنذكر الضجة الكاذبة التي أثاروها حول قيامته المجيدة, أي أن تلاميذته سرقوا جسده, ولست أدري كيف أن هذه الشائعة الكاذبة, استطاعت على الرغم من جسامة الكذب فيها ومما لفقته من كل جهة, وعلى الرغم من المال المبذول لرشوى الجنود وشراء سكوتهم, وعلى الرغم من برهان بقاء الكفن في الفبر, على الرغم من كل هذا استطاعت تلك الشائعة ان تسري في الجمهور.
ذلك أن الجمهور لم تكن عنده أية فكرة عن القيامة, والتلاميذ أنفسهم لم يكونوا قد فهموا أنه يجب أن يقوم من بين الأموات. ومع كل هذا فإن الله بصبره ترك كل شئ يجري, مرتباً في أسرار حكمته الغير المحدودة.
وفي الأيام التالية .. نرى التلاميذ يختبئون من جديد، ويتوارون عن الأبصار. يهربون تحت سيطرة الخوف، مرتعدين دائماً، مغيرين أقامتهم دائماً. وبعد الاختفاء على هذا النحو مدة خمسين يوماً، تراهم يظهرون من جديد، متميزين بالعجائب مستعدين للبشارة. وتظهر المقاومة ويتجدد الرعب، وتتشكك الأنفس الضعيفة ثانية حين ترى الرسل يُجلدون والمؤمنين يُضطهدون والتلاميذ يطردون وذلك في الظفر الهام والعام لأعداء الكنيسة.
وحين تدعم العجائب المكملة على أيدي الرسل كلامهم بالسلطان القوي, يأتي مقتل القديس أستفانوس نذيراً بعنف الأضطهاد الذي شتّت المؤمنين وألقى الرعب في صفوفهم, فنرى التلاميذ من جديد في الضيق والخوف والهرب.
وهكذا , وفي هذه المحن والتجارب كانت الكنيسة تنمو وتتزايد. كانت تزدهر من خلال معجزات التبشير والعجائب والاضطاد. ومنذ فجر ولادتها كانت تتفجّر ضياءً باهراً.
هُرّبَ بولس الرسول من نافذة السور, وتخلص من يدي حاكم دمشق. وجاء ملاك يخرج بطرس الرسول من السجن ويفك السلاسل من يديه ورجليه. وآوى الرسل المطرودين من وجه أقوياء هذا العالم تجار صغار, وأناس فقراء عائشون من تعب أيديهم, آووهم في بيوتهم وأحاطوهم بكل عناية: بائعات أقمشة وصُنّاع خيام, دبّاغون في أقصى الضواحي, وقرب الشواطئ وعلى حافة البحر, هؤلاء آووا الرسل من الأضطهاد. ولم يكن الرسل ليتجاسروا, أكثر الوقت, على الظهور, وإذا تجاسروا مرة, ففي الخفاء ومن غير أن يبصرهم أحد.
ففي وسط هذه المحن وفي وسط هذه الأفراح كان قطيع المسيح يتزايد. وهكذا نرى الذين كانوا يختبئون ينهضون ويظهرون، والذين كانوا تائهين يعودون إلى الحظيرة، وما كان مهدماً إلى الأرض قد أعيد تعميره على أكمل وجه.
واذكرى في الكتاب بولس إذ كان الله، بحكمته ووسائل تدبيره غير المحدودة، يرفض سؤاله السلام والهدوء من أجل نشر الإنجيل وعلى الرغم من تكرار سؤاله لم يكن يجيبه إلا بقوله: “تكفيك نعمتي. إن قوتي بالضعف تكمل” (2 كو 9:12). والآن إذا أردتِ أن تقارني أفراحنا وأحزاننا بتلك الأحداث الماضية، فستجدين أحداثنا، إذا لم تكن عجائب ومعجزات، فهي أشبه بالعجائب والمعجزات، أو أنها على الأقل براهين قاطعة من براهين العناية الإلهية، وأن يد الله فيها. ولكي لا أكلف نفسي بكل هذا الأمر, ولكي لا أوفر عليك كل الأهتمام, أترك لكِ أنتِ أمر الفحص عن تعزيتنا ومكافأتنا ومقابلتها مع تجاربنا. وهكذا أكون قد أسلمتك إلى انشغال حسن سينزع منكِ حزنكِ, وستنتزعين أنتِ منه تعزية كبرى.
تفضلي وقدمي عني أطيب تمنياتي إلى كل أهل بيتكِ المبارك. وتمكني أنتِ نفسكِ أيتها السيدة الجزيلة الأحترام والتقوى, تمكني من أن تنعمي دائماً بالصحة الجيدة ةبالفرح الكامل. إذا أردتِ أن تكتبي لي كتاباً مطولاً، فأظهري لي، بطيبة خاطر وبصراحة من غير أن تغشيني، أنك طرحتِ كل حزنك، وأنك وجدت السلام والهدوء لنفسك. هذا هو هدفي من الكتابة لك أن أعيد الفرح إلى نفسكِ. وأريد أيضاً ان أكتب مطولاً. لا تقولي لي أن رسائلي هي تعزيتكِ الكبرى: هذا ما أعرفه. ولكن قولي أن نفسكِ هي مطمئنة كما أريده لكِ وأنك لست متبلبلة, وأنك لا تبكين قط, وأنك قد وجدت الفرح مع الطمأنينة.
—————–
عن كتاب “يوُحَنّا الذهبيّ الفم في الكهنوت ــ أحاديث عن الزواج ــ الرسائل إلى أولمبيا” تعريب الأسقف أستفانوس حَدّاد ــ ص 200 حتى ص 211 ــ منشورات النور
—————–
أقرأ أيضاً الهدف من رسائل القديس يوحنا ذهبي الفم إلى القديسة “أولمبياس” كما يظهر من سيرة حياتها العطرة, وحزنها الشديد علي نفي القديس.
Share this content:




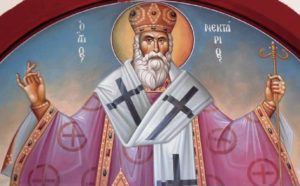





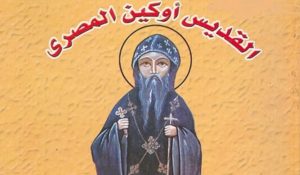























إرسال التعليق